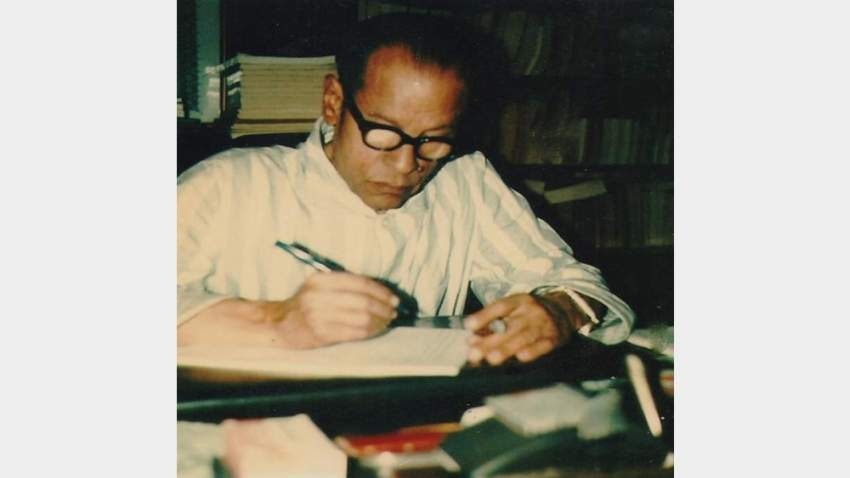2019-03-03
لا يذكر أول شيء أدركه حسه وتحققه عقله، ومن ذا الذي يذكر؟
ربما ثدي أمه لأنه من الأشياء التي تعرف بالغريزة، والتي يتحسسها الطفل بلا إدراك، ولكنه خمن ذلك تخميناً، وفي وقت متأخر عن عهد الطفولة.
نعم تذكر ذلك كما تذكر غيره، ولكن كان مصدر تفكيره الخيال لا الذاكرة، فكثيراً ما كان يحدث نفسه قائلًا: «لقد كنت طفلاً، وطفلاً صغيراً ليس له مرتع غير حجر أمه».
ثم يسرح فكره ويظل يفكر في الصورة التي خلقها خياله، وهي صورة يرتاح لها ضميره، ولكنها ليست غريبة فمن منا لم ير طفلاً يعبث على مقربة من أمه؟ ألم نكن كلنا أطفالاً؟ وكان طفلاً ليس له إدراك ولا تمييز ثم لا يزال يتناوله الزمن بالتكوين حتى يخرجه إنساناً، ليمثل رواية معينة بيد القدر التي تسلمه للفناء.
كان يفكر في تلك الصورة، وإذا وجد طفلاً صغيراً يزيد بلباله وتفكيره، ثم تتناوله يد الخيال فتصور له ما شاءت أن تصور.
ومهما تكن ذاكرته فهو يذكر جيداً حجرة صغيرة على سطح منزل بسيط في حي من الأحياء الوطنية، يذكر الحجرة دائماً، فهي أمامه بأرضها المعوجة وسقفها الخشبي وأركانها القذرة ونافذتها الخشبية، كل في مخيلته ولا يمكن أن ينسى شيئاً منها، وكيف ينسى شيئاً منها وقد وعاها قبل أن يعي أي شيء خارجي؟
فهو كأنه ولد فيها، ولم يدعها ثانية واحدة من حياته، وهي لذلك كانت محبوبة لديه، ومحبوبة جدّاً، وكثيراً ما كان يقعد على حافة النافذة يراقب المارين من بين «الشيش»، وهكذا كان يمضي كثيراً من يومه على هذه النافذة المحبوبة يراقب ويتمنى!
وكان ينام فيها صيفاً وشتاء، تُفرش المرتبة على الأرض وتحتضنه أمه بين يديها، وتظل تقص عليه القصص صادقها وكاذبها، أو تقرأ له بعض الآيات القرآنية، وهي أثناء ذلك تدلك جسمه حتى يرفق الكرى بجفونه ويستسلم لسلطان النوم الجميل.
ما أجمل ذلك العقد!
لقد كان يظن نفسه ملك العالم كله، أليست له الحجرة بأكملها، أليست أمه تقص عليه ما تشتهيه نفسه من القصص، ثم هو يأكل ويشرب، فما الذي بقي ليناله؟
نعم كان ملكاً، وكانت هذه الحجرة عاصمة ملكه، وأما السطح فبقية القطر العظيم، وكانت فيه عشتان خشبيتان، أولاهما للدجاج والثانية «للخزين»، فكان إذا ترك الحجرة الصغيرة تمشى على أرض السطح بقدميه الحافيتين الصغيرتين.
وكان كثيراً ما يلعب في «جحر» عشة الفراخ، ويعبث به ويسر إذا صاح واضطرب، وأما عشة الخزين فكان قليلاً ما يدخلها، لأنه كان يفزع من الفئران ويقشعر بدنه من شكلها، ومع هذا كان يشفق عليها وقد يبكي إذا قُتل فأر أمامه، وكان يستيقظ مبكراً فينهض من فراشه ويستقبل الشمس من خلال اللبلاب المخيم على باب الحجرة من أعلى، وكانت أمه تعتني بهذا اللبلاب، كما كانت تعتني بغيره من الشجيرات التي كانت تزين بها سور السطح.
وكان هو أيضاً يحب اللبلاب، وكان يمتع نظره كل صباح بأوراقه الصغيرة الخضراء وقد كستها أشعة الشمس حلة زاهية من أسلاكها الذهبية، ولا يزال يمعن النظر في الأوراق الخضراء والشمس الجميلة والسماء الزرقاء، وهو يظن أن ذلك كل ما يحوي العالم من كائنات حية وميتة، ثم يقوم ليغسل وجهه ويبدأ في لعبه ولهوه كما يشاء!
وكان شاطراً في لهوه وعبثه حتى إن والدته كانت تلجأ لضربه كثيراً رغم حبها له، وكانت تحبه كثيراً، بل قلما فاز طفل بحب مثل الذي فاز به هذا الطفل من أمه، ولم يكن وحيداً بل كان آخر سبعة، أربع بنات وشابان، وقد أعلمته والدته بأن أختاً له ماتت وكانت الكبرى، ولكن أمه كانت تحبه كأنه وحيد ولم يكن لحبها حد أو نهاية، نعم إنها كانت تحب إخوته وأخواته لما طبع عليه قلب كل أم من الشفقة والحنان نحو أطفالها، ولكن حبها له كان يفوق حبها لجميع أولادها.
وكان هو يحبها حبّاً عظيماً، ويتدلل عليها دلالاً كبيراً، وكان مجرد مفارقته لها ساعة أو اثنتين فاجعة لا تحتمل ولا يستطيع أن يتحملها قلبه الصغير، وكانت إذا مرضت مضى مدة مرضها يبكي ويتحسر، وفي الواقع كان هو الآخر يحبها حبّاً لا تفوز به الأمهات عادة، وكيف يكرهها وهو الذي يحب الحيوان والنبات والجماد فيغرم بالدجاج، ويبكي لموت الفئران ويهوى اللبلاب.. نعم هو يحب كل شيء ويشفق على كل شيء، فكيف لا يحب بل ويعبد أمه.
ولقد فكر بعد مضي زمن في هذا الحب الغريب الذي كان بينه وبين أمه، فشعر بأنه كان الحب الذي فاز به في الحياة، ولولاه لآزر الموت قبل أن يدرك ماهية الحياة! فالطبيعة مهما تجور تعدل في التوزيع على البشر، كان يحب أمه وهو يحبها أن تخلد له لأنها كل شيء له!
وكان يحدث في بعض الأحيان أن يزداد في لعبه حتى يخرج عن الحد فيقلق إخوته، ويُحدث شغباً ويأتي بأخطر الألعاب التي تؤذيه قبل غيره، فكانت أمه تزجره وقد تضربه ضرباً موجعاً، ولم يكن يقنع بل ربما تعدى هو الآخر عليها فيعض يدها أو يسبُّها، ولكنه لا يلبث أن يندم ويؤلمه الندم، فيبكي ثم يزداد البكاء فيصير عويلاً ويزداد العويل فيصير صياحاً، حتى ترجع أمه تهون عليه وتقبله، فيهدأ ويقبلها، ويسود السلام مرة أخرى، إلا أن هذه الرواية كانت تتكرر كثيراً، ولكنها لا تتغير فاللعب كما هو والضرب كما هو ثم البكاء والصلح كما هو.
ولما كانت «تَغلب» منه ومن «شقاوته»، كانت تهدده بالأرواح وتتوعده بإرسال روح له في الحلم تزعجه وتخيفه وتنغص عليه الراحة، فكان يظهر عدم الاكتراث، ولكن قلبه يضطرب من الرعب، فيجلس القرفصاء يفكر في العفريت الموهوم وفي الأحلام ويود لو أنه لا ينام أبداً، ويظل ساهراً بعيداً عن المخاوف، ولما كانت أمه تلاحظ عليه الصمت والوجوم، تبدأ تزيل ما تجمع من مخاوفه وتعده بأنها ستبعد عنه الشياطين بما تتلوه عليه من آيات القرآن، إذن فآيات القرآن تزيل الشياطين!
فلا بد له من أن يحفظ شيئاً من هذه الآيات ليتحصن بها ضد جميع الأرواح المخيفة، فكان ينصت لأمه وهي تتلو عليه «الحمد لله رب العالمين» أو «قل هو الله أحد» و«قل أعوذ برب الناس» حتى حفظها جيداً، وصار يتلوها دائماً كل مساء، فينام مطمئن البال مستريح الفؤاد، قلبه واثق بالنوم السعيد الخالي من الأحلام المخيفة والأرواح الشيطانية، وكان لا يعرف معنى الآيات التي يرددها، ولم يكن يهتم لذلك كثيراً، ولم يحاول مرة أن يسأل عن ذلك، فحسبه أنها تزيل المخاوف وتبعد الأحلام المرعبة، والأعظم من كل ذلك أنها من كلام «الله» الذي أوجد الدنيا والنجوم والشمس والقمر، والذي يفتح أبواب الجنة للمؤمنين، والذي يحرق الكافرين في جهنم.. نعم حسبه أن يردد الآيات فيظفر بالنوم السعيد، ولكنه كان عنيداً صلب الرأي لا يريح أحداً، ويزعج كل أحد، فهو إن لعب قَلبَ الأشياء من أثاث ومقاعد، فغير هندام الغرف، ووسَّخ الأماكن وجرح نفسه، وإن أراد النوم فلا بد من أن يدلك جسمه وقتاً طويلاً، أو أن ترفعه أمه بين يديها وتسير به ذهاباً وإياباً، أو تصعد به إلى السطح ثم تنزل به إلى باب الخروج، وهو متمسك بكتفها حتى تنحل قواها ويتصبب العرق من جبينها وتوهن أعصابها، وإذا أرادت الراحة قليلاً بكى وصرخ وحثها على السير حتى إنه قد ينتهي الأمر بضربه أو سبه، وإذا أراد الأكل أكل بمفرده بعيداً عن إخوته، حتى عن أمه المحبوبة، ولم يكن يأكل مع أحد إلا أبيه أو أخيه الأكبر وأخيه الثاني، وربما كان والده الوحيد الذي يخشاه ويرتعب من ذكر اسمه، نعم لقد كان يداعبه كل صباح فيفرد أصابعه ويعد له «آدي البيضة آدي اللي شواها، واللي هات حتة حتة .. إلخ»، ثم يعبث أصابعه بين إبطه حتى يغرق الطفل في الضحك، ولكنه كان إذا غضب عليه ضربه ضرباً أليماً، حتى إن كلمة من والده كانت تعد أمراً لا يمكن مخالفته، إلا إذا خرج الوالد إلى العمل، فإنه يستحوذ على النفوذ فيعبث ويلعب كما يشاء.
وقد كان يصل به الأمر إلى ضرب أخواته إذا اشتد خلاف، وكن يضربنه رغم حبهن له إلا الأخت الكبيرة فإنها كانت تحبه ولا تستطيع ضربه أبداً.
وكانت أخته التي تلي هذه تحبه كذلك، ولا تتأخر عن إظهار حبها كلما سنحت الفرصة، وربما كان هو يحبها أكثر من الجميع، والتي تلي هذه كانت تشتهر بالذكاء والفطنة والدهاء، فكانت لذلك تشعر «بنفسها»، ولم تسمح له بأن يتعدى عليها مطلقاً، لذلك كان ينفر منها قليلاً، والصغرى كانت لها صفات محبوبة وكانت مولعة به، كثيرة العناية بحاجياته، ولذا كان يغرم بها.
وكان الهم الأكبر لأخته الكبرى «الخِياطة»، فكانت تقضي الأيام الطوال أمام الآلة تخيط الملابس أو تلهو بالتطريظ [التطريز]، وهي تتحرك على نغمات بعض الأغنيات الشعبية، وكان يجلس أمامها في كثير من الأحايين يراقبها بعينيه ويتأمل يدها السريعة التي لا تخطئ أبداً، ولم يكن يرحمها من مداعباته المزعجة، فكثيراً ما عاكسها وهي تشتغل، فمثلًا كان يحكم عليها أن تنزع القماش من مكانه، وتخلع الإبرة من ثقبها ثم يجلس هو يدير الآلة كما يشاء، فيشعر بلذة خاصة.
كما كان يأخذ المقعد الذي ترتكز عليه الآلة، ويجره أمامه كأنه عربة أو يمتطيه كأنه حصان، فكانت أخته في أكثر الأحوال تدعه يفعل ما يشاء، لعلمها بأنها إذا عارضته صخب وصرخ وآذاها ولم يُجدِ معه زجر أو عقاب، وكانت تلجأ في كثير من الأحايين إلى محايلته وتسليته، كأن تقص عليه بعض «الحكايات» عن الشياطين أو اللصوص، فكان ينصت بكل جوارحه، ويلهو عن كل شيء في السماء والأرض، لأن الحكاية كانت أفيونته!
وما أكثر حكايات أخته هذه، لم يكن يفوقها في ذلك المضمار إلا أمه نفسها! ثم هي في المرتبة الثانية والأخيرة تقريباً.
وكانت معظم حكاياتها عما شاهدته من الشياطين و«المزورات» في منزل كانت تسكنه العائلة قبل أن تقطن في هذا المنزل، فكانت تشرح له بإسهاب كيف أنها أثناء نومها، وفي الهزيع الأخير من الليل، كانت تسمع وقع أقدام ثقال في بهو المنزل، ولا تزال هذه الخطوات مستمرة حتى مطلع الفجر، وحتى يصيح المؤذن «الله أكبر ولا إله إلا الله».
هنالك تفر الشياطين أمام صوت الله ويخيم السلام على العالم، ولقد انغرست هذه الفكرة في عقله ولم ينسها لحظة واحدة من حياته، فكان إذا أصابه سهاد في إحدى الليالي يغمض عينيه خشية أن يرى شبحاً أو عفريتاً، وينكمش تحت أذرع أمه حذراً أن تخطفه «مزورة»، ويضع الغطاء على رأسه لئلا يسمع وقع أقدام شيطان أو «مزورة»، ولكن إذا ما تجلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود وصاح المؤذن «الله أكبر ولا إله إلا الله»، فردد صداه آلاف الديوك بأصواتها الشجية، هنالك يزيل اللحاف ويفتح عينيه ويبتعد عن أمه قليلاً دون أن يخشى شيئاً.
ما أجمل الفجر، لقد كان ينقذه من مخالب الأوهام المخيفة، فكان يحبه لذلك، كما كان يحبه لسكونه وجاذبيته، كما كان يحبه لسمائه وديوكه ونجومه، وهكذا كان في صغره ثم ازداد هذا الحب لما ترعرع، ولا يزال يعشق الفجر كما سيعشقه دائماً في هذه المرحلة، حتى يحول بينه وبين رؤيته سطح الأرض وتسد أذنه عن سماع ديوكه يد الموت الأبدية!
ولكنه لم يكن يفكر في الموت في ذلك العهد، بل كان هذا الموت شيئاً بعيد الوقوع - أو على الأقل له هو - لأن أباه شيخ عجوز ومع ذلك لم يمت. هل يموت هو الذي لم يبلغ الرابعة من عمره؟ كلَّا وألف كلَّا.
هكذا كان تأثير حكاية واحدة على عقله.. لم تكن الحكاية تنتهي بانتهاء قولها، كلَّا، بل إن هذا الانتهاء هو بدؤها، فهو يتسلمها ثم يستسلم للتفكير فيها، ويسرح خياله فيصور له الحكاية وأشخاصها وأبطالها وضحاياها، ثم يضع نفسه مكان كل واحد من هؤلاء فيشعر بالخوف تارة والاطمئنان أخرى، وبالجبن مرة وبالشجاعة مرة والضعف فينة وبالقوة فينة، ثم يلقي للحاكي بعض أسئلة عن ماهية العفريت أين يعيش أو كيف يعيش؟ ولماذا يؤذينا؟ ولماذا يتركه الله دون عقاب؟ فكانت الردود أن العفريت شيء لا نستطيع فهمه، وكل ما يقال عنه أنه قوي مهول يوجد في كل مكان ويستطيع أن يفعل ما يشاء، وهو ينام في منازل مخصوصة في عالمه المجهول لدينا، وهو يؤذينا لأنه جزء من الشر، وأما عن ترك الله له فهذه حكمته هو يعلمه عن نفسه، ولا نستطيع أن نسأل عما يفعل الله لأنه يعرف ماذا يفعل!
غدا: حلقة جديدة
ربما ثدي أمه لأنه من الأشياء التي تعرف بالغريزة، والتي يتحسسها الطفل بلا إدراك، ولكنه خمن ذلك تخميناً، وفي وقت متأخر عن عهد الطفولة.
نعم تذكر ذلك كما تذكر غيره، ولكن كان مصدر تفكيره الخيال لا الذاكرة، فكثيراً ما كان يحدث نفسه قائلًا: «لقد كنت طفلاً، وطفلاً صغيراً ليس له مرتع غير حجر أمه».
ثم يسرح فكره ويظل يفكر في الصورة التي خلقها خياله، وهي صورة يرتاح لها ضميره، ولكنها ليست غريبة فمن منا لم ير طفلاً يعبث على مقربة من أمه؟ ألم نكن كلنا أطفالاً؟ وكان طفلاً ليس له إدراك ولا تمييز ثم لا يزال يتناوله الزمن بالتكوين حتى يخرجه إنساناً، ليمثل رواية معينة بيد القدر التي تسلمه للفناء.
كان يفكر في تلك الصورة، وإذا وجد طفلاً صغيراً يزيد بلباله وتفكيره، ثم تتناوله يد الخيال فتصور له ما شاءت أن تصور.
ومهما تكن ذاكرته فهو يذكر جيداً حجرة صغيرة على سطح منزل بسيط في حي من الأحياء الوطنية، يذكر الحجرة دائماً، فهي أمامه بأرضها المعوجة وسقفها الخشبي وأركانها القذرة ونافذتها الخشبية، كل في مخيلته ولا يمكن أن ينسى شيئاً منها، وكيف ينسى شيئاً منها وقد وعاها قبل أن يعي أي شيء خارجي؟
فهو كأنه ولد فيها، ولم يدعها ثانية واحدة من حياته، وهي لذلك كانت محبوبة لديه، ومحبوبة جدّاً، وكثيراً ما كان يقعد على حافة النافذة يراقب المارين من بين «الشيش»، وهكذا كان يمضي كثيراً من يومه على هذه النافذة المحبوبة يراقب ويتمنى!
وكان ينام فيها صيفاً وشتاء، تُفرش المرتبة على الأرض وتحتضنه أمه بين يديها، وتظل تقص عليه القصص صادقها وكاذبها، أو تقرأ له بعض الآيات القرآنية، وهي أثناء ذلك تدلك جسمه حتى يرفق الكرى بجفونه ويستسلم لسلطان النوم الجميل.
ما أجمل ذلك العقد!
لقد كان يظن نفسه ملك العالم كله، أليست له الحجرة بأكملها، أليست أمه تقص عليه ما تشتهيه نفسه من القصص، ثم هو يأكل ويشرب، فما الذي بقي ليناله؟
نعم كان ملكاً، وكانت هذه الحجرة عاصمة ملكه، وأما السطح فبقية القطر العظيم، وكانت فيه عشتان خشبيتان، أولاهما للدجاج والثانية «للخزين»، فكان إذا ترك الحجرة الصغيرة تمشى على أرض السطح بقدميه الحافيتين الصغيرتين.
وكان كثيراً ما يلعب في «جحر» عشة الفراخ، ويعبث به ويسر إذا صاح واضطرب، وأما عشة الخزين فكان قليلاً ما يدخلها، لأنه كان يفزع من الفئران ويقشعر بدنه من شكلها، ومع هذا كان يشفق عليها وقد يبكي إذا قُتل فأر أمامه، وكان يستيقظ مبكراً فينهض من فراشه ويستقبل الشمس من خلال اللبلاب المخيم على باب الحجرة من أعلى، وكانت أمه تعتني بهذا اللبلاب، كما كانت تعتني بغيره من الشجيرات التي كانت تزين بها سور السطح.
وكان هو أيضاً يحب اللبلاب، وكان يمتع نظره كل صباح بأوراقه الصغيرة الخضراء وقد كستها أشعة الشمس حلة زاهية من أسلاكها الذهبية، ولا يزال يمعن النظر في الأوراق الخضراء والشمس الجميلة والسماء الزرقاء، وهو يظن أن ذلك كل ما يحوي العالم من كائنات حية وميتة، ثم يقوم ليغسل وجهه ويبدأ في لعبه ولهوه كما يشاء!
وكان شاطراً في لهوه وعبثه حتى إن والدته كانت تلجأ لضربه كثيراً رغم حبها له، وكانت تحبه كثيراً، بل قلما فاز طفل بحب مثل الذي فاز به هذا الطفل من أمه، ولم يكن وحيداً بل كان آخر سبعة، أربع بنات وشابان، وقد أعلمته والدته بأن أختاً له ماتت وكانت الكبرى، ولكن أمه كانت تحبه كأنه وحيد ولم يكن لحبها حد أو نهاية، نعم إنها كانت تحب إخوته وأخواته لما طبع عليه قلب كل أم من الشفقة والحنان نحو أطفالها، ولكن حبها له كان يفوق حبها لجميع أولادها.
وكان هو يحبها حبّاً عظيماً، ويتدلل عليها دلالاً كبيراً، وكان مجرد مفارقته لها ساعة أو اثنتين فاجعة لا تحتمل ولا يستطيع أن يتحملها قلبه الصغير، وكانت إذا مرضت مضى مدة مرضها يبكي ويتحسر، وفي الواقع كان هو الآخر يحبها حبّاً لا تفوز به الأمهات عادة، وكيف يكرهها وهو الذي يحب الحيوان والنبات والجماد فيغرم بالدجاج، ويبكي لموت الفئران ويهوى اللبلاب.. نعم هو يحب كل شيء ويشفق على كل شيء، فكيف لا يحب بل ويعبد أمه.
ولقد فكر بعد مضي زمن في هذا الحب الغريب الذي كان بينه وبين أمه، فشعر بأنه كان الحب الذي فاز به في الحياة، ولولاه لآزر الموت قبل أن يدرك ماهية الحياة! فالطبيعة مهما تجور تعدل في التوزيع على البشر، كان يحب أمه وهو يحبها أن تخلد له لأنها كل شيء له!
وكان يحدث في بعض الأحيان أن يزداد في لعبه حتى يخرج عن الحد فيقلق إخوته، ويُحدث شغباً ويأتي بأخطر الألعاب التي تؤذيه قبل غيره، فكانت أمه تزجره وقد تضربه ضرباً موجعاً، ولم يكن يقنع بل ربما تعدى هو الآخر عليها فيعض يدها أو يسبُّها، ولكنه لا يلبث أن يندم ويؤلمه الندم، فيبكي ثم يزداد البكاء فيصير عويلاً ويزداد العويل فيصير صياحاً، حتى ترجع أمه تهون عليه وتقبله، فيهدأ ويقبلها، ويسود السلام مرة أخرى، إلا أن هذه الرواية كانت تتكرر كثيراً، ولكنها لا تتغير فاللعب كما هو والضرب كما هو ثم البكاء والصلح كما هو.
ولما كانت «تَغلب» منه ومن «شقاوته»، كانت تهدده بالأرواح وتتوعده بإرسال روح له في الحلم تزعجه وتخيفه وتنغص عليه الراحة، فكان يظهر عدم الاكتراث، ولكن قلبه يضطرب من الرعب، فيجلس القرفصاء يفكر في العفريت الموهوم وفي الأحلام ويود لو أنه لا ينام أبداً، ويظل ساهراً بعيداً عن المخاوف، ولما كانت أمه تلاحظ عليه الصمت والوجوم، تبدأ تزيل ما تجمع من مخاوفه وتعده بأنها ستبعد عنه الشياطين بما تتلوه عليه من آيات القرآن، إذن فآيات القرآن تزيل الشياطين!
فلا بد له من أن يحفظ شيئاً من هذه الآيات ليتحصن بها ضد جميع الأرواح المخيفة، فكان ينصت لأمه وهي تتلو عليه «الحمد لله رب العالمين» أو «قل هو الله أحد» و«قل أعوذ برب الناس» حتى حفظها جيداً، وصار يتلوها دائماً كل مساء، فينام مطمئن البال مستريح الفؤاد، قلبه واثق بالنوم السعيد الخالي من الأحلام المخيفة والأرواح الشيطانية، وكان لا يعرف معنى الآيات التي يرددها، ولم يكن يهتم لذلك كثيراً، ولم يحاول مرة أن يسأل عن ذلك، فحسبه أنها تزيل المخاوف وتبعد الأحلام المرعبة، والأعظم من كل ذلك أنها من كلام «الله» الذي أوجد الدنيا والنجوم والشمس والقمر، والذي يفتح أبواب الجنة للمؤمنين، والذي يحرق الكافرين في جهنم.. نعم حسبه أن يردد الآيات فيظفر بالنوم السعيد، ولكنه كان عنيداً صلب الرأي لا يريح أحداً، ويزعج كل أحد، فهو إن لعب قَلبَ الأشياء من أثاث ومقاعد، فغير هندام الغرف، ووسَّخ الأماكن وجرح نفسه، وإن أراد النوم فلا بد من أن يدلك جسمه وقتاً طويلاً، أو أن ترفعه أمه بين يديها وتسير به ذهاباً وإياباً، أو تصعد به إلى السطح ثم تنزل به إلى باب الخروج، وهو متمسك بكتفها حتى تنحل قواها ويتصبب العرق من جبينها وتوهن أعصابها، وإذا أرادت الراحة قليلاً بكى وصرخ وحثها على السير حتى إنه قد ينتهي الأمر بضربه أو سبه، وإذا أراد الأكل أكل بمفرده بعيداً عن إخوته، حتى عن أمه المحبوبة، ولم يكن يأكل مع أحد إلا أبيه أو أخيه الأكبر وأخيه الثاني، وربما كان والده الوحيد الذي يخشاه ويرتعب من ذكر اسمه، نعم لقد كان يداعبه كل صباح فيفرد أصابعه ويعد له «آدي البيضة آدي اللي شواها، واللي هات حتة حتة .. إلخ»، ثم يعبث أصابعه بين إبطه حتى يغرق الطفل في الضحك، ولكنه كان إذا غضب عليه ضربه ضرباً أليماً، حتى إن كلمة من والده كانت تعد أمراً لا يمكن مخالفته، إلا إذا خرج الوالد إلى العمل، فإنه يستحوذ على النفوذ فيعبث ويلعب كما يشاء.
وقد كان يصل به الأمر إلى ضرب أخواته إذا اشتد خلاف، وكن يضربنه رغم حبهن له إلا الأخت الكبيرة فإنها كانت تحبه ولا تستطيع ضربه أبداً.
وكانت أخته التي تلي هذه تحبه كذلك، ولا تتأخر عن إظهار حبها كلما سنحت الفرصة، وربما كان هو يحبها أكثر من الجميع، والتي تلي هذه كانت تشتهر بالذكاء والفطنة والدهاء، فكانت لذلك تشعر «بنفسها»، ولم تسمح له بأن يتعدى عليها مطلقاً، لذلك كان ينفر منها قليلاً، والصغرى كانت لها صفات محبوبة وكانت مولعة به، كثيرة العناية بحاجياته، ولذا كان يغرم بها.
وكان الهم الأكبر لأخته الكبرى «الخِياطة»، فكانت تقضي الأيام الطوال أمام الآلة تخيط الملابس أو تلهو بالتطريظ [التطريز]، وهي تتحرك على نغمات بعض الأغنيات الشعبية، وكان يجلس أمامها في كثير من الأحايين يراقبها بعينيه ويتأمل يدها السريعة التي لا تخطئ أبداً، ولم يكن يرحمها من مداعباته المزعجة، فكثيراً ما عاكسها وهي تشتغل، فمثلًا كان يحكم عليها أن تنزع القماش من مكانه، وتخلع الإبرة من ثقبها ثم يجلس هو يدير الآلة كما يشاء، فيشعر بلذة خاصة.
كما كان يأخذ المقعد الذي ترتكز عليه الآلة، ويجره أمامه كأنه عربة أو يمتطيه كأنه حصان، فكانت أخته في أكثر الأحوال تدعه يفعل ما يشاء، لعلمها بأنها إذا عارضته صخب وصرخ وآذاها ولم يُجدِ معه زجر أو عقاب، وكانت تلجأ في كثير من الأحايين إلى محايلته وتسليته، كأن تقص عليه بعض «الحكايات» عن الشياطين أو اللصوص، فكان ينصت بكل جوارحه، ويلهو عن كل شيء في السماء والأرض، لأن الحكاية كانت أفيونته!
وما أكثر حكايات أخته هذه، لم يكن يفوقها في ذلك المضمار إلا أمه نفسها! ثم هي في المرتبة الثانية والأخيرة تقريباً.
وكانت معظم حكاياتها عما شاهدته من الشياطين و«المزورات» في منزل كانت تسكنه العائلة قبل أن تقطن في هذا المنزل، فكانت تشرح له بإسهاب كيف أنها أثناء نومها، وفي الهزيع الأخير من الليل، كانت تسمع وقع أقدام ثقال في بهو المنزل، ولا تزال هذه الخطوات مستمرة حتى مطلع الفجر، وحتى يصيح المؤذن «الله أكبر ولا إله إلا الله».
هنالك تفر الشياطين أمام صوت الله ويخيم السلام على العالم، ولقد انغرست هذه الفكرة في عقله ولم ينسها لحظة واحدة من حياته، فكان إذا أصابه سهاد في إحدى الليالي يغمض عينيه خشية أن يرى شبحاً أو عفريتاً، وينكمش تحت أذرع أمه حذراً أن تخطفه «مزورة»، ويضع الغطاء على رأسه لئلا يسمع وقع أقدام شيطان أو «مزورة»، ولكن إذا ما تجلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود وصاح المؤذن «الله أكبر ولا إله إلا الله»، فردد صداه آلاف الديوك بأصواتها الشجية، هنالك يزيل اللحاف ويفتح عينيه ويبتعد عن أمه قليلاً دون أن يخشى شيئاً.
ما أجمل الفجر، لقد كان ينقذه من مخالب الأوهام المخيفة، فكان يحبه لذلك، كما كان يحبه لسكونه وجاذبيته، كما كان يحبه لسمائه وديوكه ونجومه، وهكذا كان في صغره ثم ازداد هذا الحب لما ترعرع، ولا يزال يعشق الفجر كما سيعشقه دائماً في هذه المرحلة، حتى يحول بينه وبين رؤيته سطح الأرض وتسد أذنه عن سماع ديوكه يد الموت الأبدية!
ولكنه لم يكن يفكر في الموت في ذلك العهد، بل كان هذا الموت شيئاً بعيد الوقوع - أو على الأقل له هو - لأن أباه شيخ عجوز ومع ذلك لم يمت. هل يموت هو الذي لم يبلغ الرابعة من عمره؟ كلَّا وألف كلَّا.
هكذا كان تأثير حكاية واحدة على عقله.. لم تكن الحكاية تنتهي بانتهاء قولها، كلَّا، بل إن هذا الانتهاء هو بدؤها، فهو يتسلمها ثم يستسلم للتفكير فيها، ويسرح خياله فيصور له الحكاية وأشخاصها وأبطالها وضحاياها، ثم يضع نفسه مكان كل واحد من هؤلاء فيشعر بالخوف تارة والاطمئنان أخرى، وبالجبن مرة وبالشجاعة مرة والضعف فينة وبالقوة فينة، ثم يلقي للحاكي بعض أسئلة عن ماهية العفريت أين يعيش أو كيف يعيش؟ ولماذا يؤذينا؟ ولماذا يتركه الله دون عقاب؟ فكانت الردود أن العفريت شيء لا نستطيع فهمه، وكل ما يقال عنه أنه قوي مهول يوجد في كل مكان ويستطيع أن يفعل ما يشاء، وهو ينام في منازل مخصوصة في عالمه المجهول لدينا، وهو يؤذينا لأنه جزء من الشر، وأما عن ترك الله له فهذه حكمته هو يعلمه عن نفسه، ولا نستطيع أن نسأل عما يفعل الله لأنه يعرف ماذا يفعل!
غدا: حلقة جديدة