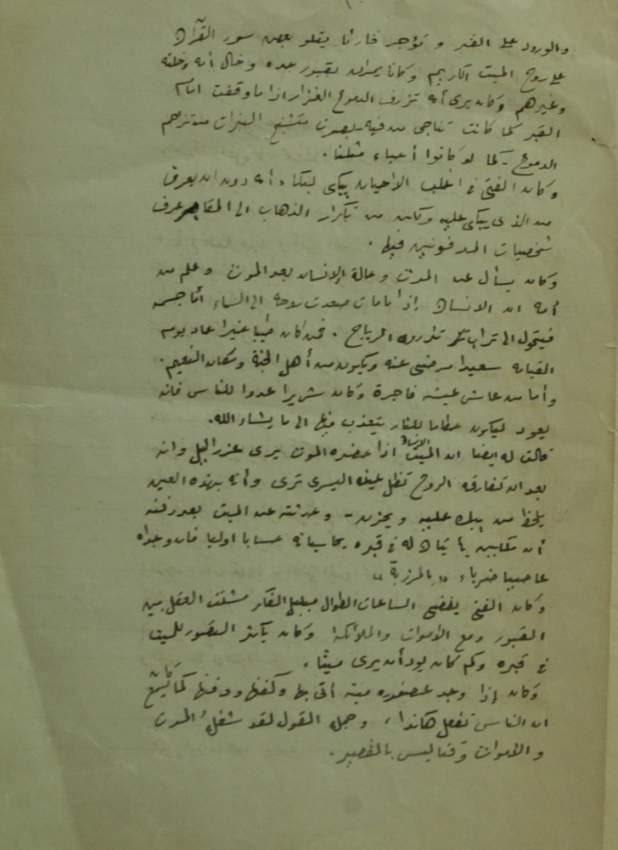2019-03-06
وقبل العهد الذي نتكلم عنه، حدث حادث جلل عمّ البلد من أقصاها إلى أدناها، وهو قيام الثورة المصرية، ولم يكن فتاناً واقفاً على بواطنها التي لا يعرفها إلا الخاصة ولا على ظواهرها التي يعلمها الناس جميعاً، وكل معلوماته كانت تناسب عقله وما يصوره له هذا، إلا أنه كان يصغي للكلام الذي يدور حول موضوع سياسي، ومن هذا أنه عرف أن هناك إنساناً اسمه سعد زغلول، وأن هذا الإنسان شجاع يحب مصر والمصريين، ويذود عنها وعنهم بكل ما يملك من قوة وحياة، وأن مصر والمصريين يحبانه ويقدسانه جزاء وفاقاً.
ولم يكن الأمر قاصراً على ذلك، بل تعداه كثيراً، فكم من مرات جلس الفتى إلى نافذة حجرته السطحية يشاهد المظاهرات يقوم بها الشعب، وكانت تتكون من مئات الألوف من الشبان والرجال والأطفال والنساء والبنات، وجملة جميع الشعب، وكان بعض هذه المظاهرات يسير بسلام دون أن يحدث ما يعكر الجو، وبعضها كان كله شغباً وفزعاً، فكانت الجنود المصرية تتحرش بالمتظاهرين وتوسعهم ضرباً وإهانات، وقد يلجأون إلى إطلاق النار، فيُقتل من يقتل من الجانبين، وقد كان الطفل يفرح للمظاهرات السلمية، ويدعو الله أن يرسل كل يوم واحدة ليمضي سحابة نهاره في مشاهدتها والتمتع بمراقبتها والإصغاء إلى هتافاتها الصارخة العالية؛ «تحيا مصر»، «تحيا الحرية»، «فليحيا سعد»، «مصر للمصريين» إلى آخره مما لا حصر له.
وقد كان طفلنا يحفظ ذلك حفظاً جيداً حتى إذا انتهى كل شيء وأوى إلى سطح المنزل جمع الخادمة وبعض الأطفال وطاف بهم ينادي النداءات التي حفظها ويرددونها خلفه، يقلد بذلك ما شاهدته عيناه أثناء اليوم. بل كان يفعل ما هو أشد عجباً، إذ كان يجمع «نوى البلح» حتى صار عنده المئات منه، ثم يقسّم النوى إلى أقسام مختلفة، فأكثرها يبذره ها هنا وها هنا يمثل به المتظاهرين، وكان يجعلها على غير نظام، ثم ينظم الجزء الباقي منها على شكل صفوف طوال يمثل بها الجند الإنجليزية أو المصرية، وعلى هذه الحال يشاهد أمامه المتظاهرين والجنود فيبدأ بتسيير المظاهرة وينتهي بتشتيتها بعد أن يمثل المعركة تمثيلاً متقناً. وكانت تمضي عليه الساعات الطوال وهو منكب على رقبته، يرنو بنظره إلى الأرض يدبر القضاء ويحكم بالموت والحياة!
***
وفي ذات سحر استيقظ الصبي على ضوضاء وتهامس، فجلس في مرتبته ورأى أمه وإخوته يتحدثون باضطراب، ويقومون بين كل آونة وأخرى فيطلون من النافذة ويرجعون يتحدثون واضطرابهم في ازدياد، فأخذ يسأل عن باعث انزعاجهم وهم يجيبونه «لا شيء»، ثم استراح ولكنه لم يستطع نوماً ولا راحة، ولما سئم ذلك قام إلى النافذة وأطل منها وكان الفجر في مجثمه والظلام باهت اللون بنور الفجر الجميل، والسكون يخيم إلا من أصوات قوم يتكلمون بلغة لم يفهمها الصبي، وأبصر الغلام أمام المنزل أشباحاً كثيرة كانت تملأ فراغ الميدان فعجب وتساءل، ولكنهم لم يجيبوه إلا بـ لا «لا شيء» .. «لا شيء».
وأخذ الظلام ينقشع والنور الأبيض يخضب جبين الفضاء، واستطاع الصبي أن يتبين ما أمامه، فصرخ في نفسه الإنجليز!
كان الإنجليز يحتلون مراكز البوليس ليستطيعوا أن يتسلطوا على المدينة ويكبحوا جماح المتظاهرين ويتمكنوا من تشتيتهم، وأخذ الصبي ينوح ويبكي لأنه ظن أن الإنجليز سيقتلونهم، وأخذت أمه تهدئ خاطره ولو أنها كانت في حاجة إلى من يهدئ خاطرها هي، وأخذت هي وبناتها يدعون الله أن ينقذ الجميع بقوته ورحمته!
وذاع الخبر في المنزل وخفق كل قلب بالخوف والرعب، وقد مهد لذلك وبالغ فيه ما كان يُروى عن فظائع الإنجليز وإهلاكهم من يقع تحت أيديهم، حتى صار اسمهم مصدر خوف وباعث فزع واضطراب. ولما درى الأب هدّأ خاطر الأسرة المضطربة وطمأنهم بقوله إن الإنجليز لم يأتوا ليصوبوا مدافعهم صوب المنازل الآمنة، إنما ليطفئوا نيران الثورة الملتهبة أينما امتد لهيبها، وقد أمرهم وشدد عليهم في ألا يفتحوا نافذة من النوافذ التي تواجه الميدان، كما حذر عليهم الخروج من باب المنزل إلا للضرورة التي لا محيد عنها. وكان الصبي لا يكاد يترك النافذة طوال نهاره قاعداً يرنو بنظره من خلف «الشيش» يشاهد الإنجليز وهم يذهبون ويجيئون تارة يغنون ويلهون، وتارة يتمرنون، وثالثة يتأهبون للقتال إذا ما نمى إليهم خبر بقيام إحدى المظاهرات العظيمة.
ولم يكن الصبي يعجب لشيء عجبه لغذائهم لأنه لم يعهد غذاء على هذا النحو من قبل، وكان يتحدث عن «الطعام الملخبط» كثيراً وبلا انقطاع. ومن الغريب أنه آنس بالإنجليز وعطف عليهم لجمال وجوههم، حتى كان كثيراً ما يلعب كعادته أمام الدار دون أن يخشاهم، بل كان يقترب منهم حتى كلمه بعضهم، وصاروا يقدمون له أنواعاً من الفطائر والحلوى، ولكن أباه كان جاهلاً بهذا الأمر ولا يدري ـ حتى ـ عن خروجه شيئاً.
ولقد فات زمن طويل والإنجليز معسكرون أمام المنزل وأهل المنزل لا يدعهم القلق ساعة واحدة، إلا الصبي الذي كان مسروراً بوجودهم ـ وأخيراً انسحب الجند وذهبوا إلى معسكر آخر، وقد كان فرح الأهل عظيماً لا حدّ له، كما كان حزن الصبي عميقاً لا غور له.
***
وكان الصبي يجلس كل مساء في «حجر» أمه أمام والده، وهذا يقص ما قرأه عنه في الجرائد، ومن ذلك علم الفتى بأن سعد باشا زغلول نُفي إلى خارج القُطر، وأن الثورة في أشد حالاتها هولاً وفظاعة. وكان يسمع كذلك بحوادث القتل وإطلاق الرصاص وفرقعة القنابل في الميادين الواسعة - كما كان يسمع بالجنود التي وجدت مقتولة ومسلوبة من الأسلحة في الأزقة والحواري، حيث يتحرش بهم الوطنيون.
وفهم كذلك أن هناك وزيراً يُدعى نسيم باشا، وآخر يُدعى ثروت باشا، وأنهما مبغضان مكروهان لأسباب لا يعرف عن تفاصيلها شيئاً، وكل ما هناك فهما عدوان لسعد زغلول المحبوب، بل المعبود من الشعب كله!
ودارت الأيام وابتسم الحظ ولو ابتسامة غامضة، إذ سرعان ما أعادت السلطة الغشومة سعد إلى وطنه بعد عذاب التشريد ووحشة الغربة وآلام المرض، وأصغى الصبي إلى وصف الاحتفال الذي استقبل به الزعيم بشيء من الذهول وعدم التصديق.
وفي يوم وصول الزعيم الخالد مرت مظاهرة بالميدان الممتد أمام المنزل وجمع فيه يسوقون حماراً يضربونه بقوة ويصيحون «أحيه يا نسيم يا بو عقل طخين [تخين]»، وآخرون يضحكون ويهللون، وهكذا غرق الشعب في سروره ونسي كل شيء بعودة رئيسه سالماً كما كان، ولم يكن إنسان يستطيع النطق إلا ويهتف باسمه «يحيا سعد .. يحيا سعد» .. وفاض حبه على النفوس حتى غمرها فأحبته الناس وأحبهم.
لقد أراد الإنجليز بنفي سعد أن يقضوا على الثورة ويقضوا عليه، فازدادت الثورة اشتعالاً وعظم سعد نفوذاً وهيبة، فقد كان استعمال الشدة مع سعد وزملائه كمن يستعمل «التهوية» لإطفاء النار فيزيدها اشتعالاً واضطراماً. وكان الصبي يشترك في المظاهرات، إذ حدث ذات يوم وكان الصبي في المدرسة أن هجم بعض الطلاب عليهم وأمروا ناظر المدرسة أن يغلقها ويصرف الطلبة، وعليه فقد وجد الصبي نفسه يسير بلا وعي في وسط آلاف من الجمهور ولكنه أسرع بالذهاب إلى منزله وهو يرتجف رعباً وفرقاً.
وفي وسط هذه الآلام التي اجتاحت البلاد زمناً طويلًا لم ينسَ الصبي آلامه الخاصة التي أهمها مواظبته على الذهاب إلى المدرسة بلا انقطاع. وكان يترقب في نفسه أن تقوم مظاهرة وتطوف بمدرسته حتى تغلقها ويستريح من المدرسة ومن نظامها المرهق ومعلميها المبغضين لقلبه، كم كان يكرههم ويخشاهم، هم الذين لم يكلموه إلا بالعصا الغليظة تهوي على جسمه الصغير الضعيف، وفي ذات صباح وكانت الثورة على أشدها قصد الصبي إلى مدرسته تصاحبه خادمة ـ كثيراً ما كان ينكل بها أثناء لعبه ولهوه ـ ولما وصل إلى بابها سأل أحد فراشيها: هل الدخول مباح، أم ممنوع بسبب الهياج والمظاهرات؟ فقال له الفراش: إن من يريد الدخول من الطلبة فليدخل لا حرج عليه، ومن لا يرغب في ذلك فليذهب حيث شاء.
وهنا قال الصبي: «أنا من الذين سيذهبون حيث شاءوا»، ثم ودعه وانصرف، وأخذ يغري الخادمة بأن تكتم أمره لدى والديه وتخبرهما إذا سألاها ـ كما سيخبرهم هو ـ بأن المدرسة مغلقة أبوابها، فرجاها لذلك ودعا لها ووقف أمام مقام سيدنا الحسين مادّاً كفيه الصغيرتين، ولم ينسَ أن يهددها إن هي خالفت رجاءه، ولما وصلا المنزل وسألته أمه عن سبب رجوعه أخبرها بأن المدرسة مغلقة الأبواب، وأنه آب وهو مملوء الجوانح أسفاً لعدم تمكنه من حضور دروسه. ولكن أمه شكّت في الأمر وسألت الخادمة وأجابت عن حقيقة الحال بلا خوف ولا حذر، واضطروا إلى الرجوع فرجع إلى المدرسة دامع العينين محروق الفؤاد حقداً من خدعة الخادمة.
وقد كانت له عدة سوابق مع هذه الخادمة منها أنه كان يقلد الطبيب في مهنته ـ وقد كان معظم لعبه تقليداً لما يروقه من الناس أو الأشياء ـ وأثناء عمله للفتاة المسكينة عملية جراحية أحدث لها جرحاً بليغاً، وقد بكت الخادمة ونزلت سرّاً إلى أمه وروت لها الخبر وكشفت لها عن ساعدها، حيث ظهر لها الجرح بشعاً مؤلم المنظر. وقد ثار غضب الأم لذلك وضربته ضرباً أليماً، كما حاولت أن تجرحه جرحاً بليغاً كما جرح الفتاة بغير إثم إلا ليلهو ويلعب.
وفي الواقع كان شيطاناً مريداً وشاطراً خبيثاً لا يترك فرصة للذين حوله يستريحون فيها، ولم يكن يحل بمكان في المنزل إلا قَلَبَه رأساً على عقب، وأثار عليه الغضب والسخط، حتى نومه كان شاقّاً متعباً لأن عينيه لم تكونا لتغفلان إلا إذا أمر والدته أن تدلك له جسده دلكاً مطرداً حتى يرفق النعاس بجفنيه. وهذا ما كان يحدث له لما كان صغيراً جدّاً. بل كان يزيد على ذلك أنه كان يحمل أمه على أن ترفعه على كتفيها وتسير به في أنحاء البيت وتنزل به وتصعد حتى ينام، وكم قاست أمه من التعب والمشقة في سبيل راحته حتى اتُهمت بتدليله وتركها له الحبل، على الرغم من أنها كانت تضربه الضرب الوجيع إذا احتاج الأمر.
غداً: حلقة جديدة
ولم يكن الأمر قاصراً على ذلك، بل تعداه كثيراً، فكم من مرات جلس الفتى إلى نافذة حجرته السطحية يشاهد المظاهرات يقوم بها الشعب، وكانت تتكون من مئات الألوف من الشبان والرجال والأطفال والنساء والبنات، وجملة جميع الشعب، وكان بعض هذه المظاهرات يسير بسلام دون أن يحدث ما يعكر الجو، وبعضها كان كله شغباً وفزعاً، فكانت الجنود المصرية تتحرش بالمتظاهرين وتوسعهم ضرباً وإهانات، وقد يلجأون إلى إطلاق النار، فيُقتل من يقتل من الجانبين، وقد كان الطفل يفرح للمظاهرات السلمية، ويدعو الله أن يرسل كل يوم واحدة ليمضي سحابة نهاره في مشاهدتها والتمتع بمراقبتها والإصغاء إلى هتافاتها الصارخة العالية؛ «تحيا مصر»، «تحيا الحرية»، «فليحيا سعد»، «مصر للمصريين» إلى آخره مما لا حصر له.
وقد كان طفلنا يحفظ ذلك حفظاً جيداً حتى إذا انتهى كل شيء وأوى إلى سطح المنزل جمع الخادمة وبعض الأطفال وطاف بهم ينادي النداءات التي حفظها ويرددونها خلفه، يقلد بذلك ما شاهدته عيناه أثناء اليوم. بل كان يفعل ما هو أشد عجباً، إذ كان يجمع «نوى البلح» حتى صار عنده المئات منه، ثم يقسّم النوى إلى أقسام مختلفة، فأكثرها يبذره ها هنا وها هنا يمثل به المتظاهرين، وكان يجعلها على غير نظام، ثم ينظم الجزء الباقي منها على شكل صفوف طوال يمثل بها الجند الإنجليزية أو المصرية، وعلى هذه الحال يشاهد أمامه المتظاهرين والجنود فيبدأ بتسيير المظاهرة وينتهي بتشتيتها بعد أن يمثل المعركة تمثيلاً متقناً. وكانت تمضي عليه الساعات الطوال وهو منكب على رقبته، يرنو بنظره إلى الأرض يدبر القضاء ويحكم بالموت والحياة!
***
وفي ذات سحر استيقظ الصبي على ضوضاء وتهامس، فجلس في مرتبته ورأى أمه وإخوته يتحدثون باضطراب، ويقومون بين كل آونة وأخرى فيطلون من النافذة ويرجعون يتحدثون واضطرابهم في ازدياد، فأخذ يسأل عن باعث انزعاجهم وهم يجيبونه «لا شيء»، ثم استراح ولكنه لم يستطع نوماً ولا راحة، ولما سئم ذلك قام إلى النافذة وأطل منها وكان الفجر في مجثمه والظلام باهت اللون بنور الفجر الجميل، والسكون يخيم إلا من أصوات قوم يتكلمون بلغة لم يفهمها الصبي، وأبصر الغلام أمام المنزل أشباحاً كثيرة كانت تملأ فراغ الميدان فعجب وتساءل، ولكنهم لم يجيبوه إلا بـ لا «لا شيء» .. «لا شيء».
وأخذ الظلام ينقشع والنور الأبيض يخضب جبين الفضاء، واستطاع الصبي أن يتبين ما أمامه، فصرخ في نفسه الإنجليز!
كان الإنجليز يحتلون مراكز البوليس ليستطيعوا أن يتسلطوا على المدينة ويكبحوا جماح المتظاهرين ويتمكنوا من تشتيتهم، وأخذ الصبي ينوح ويبكي لأنه ظن أن الإنجليز سيقتلونهم، وأخذت أمه تهدئ خاطره ولو أنها كانت في حاجة إلى من يهدئ خاطرها هي، وأخذت هي وبناتها يدعون الله أن ينقذ الجميع بقوته ورحمته!
وذاع الخبر في المنزل وخفق كل قلب بالخوف والرعب، وقد مهد لذلك وبالغ فيه ما كان يُروى عن فظائع الإنجليز وإهلاكهم من يقع تحت أيديهم، حتى صار اسمهم مصدر خوف وباعث فزع واضطراب. ولما درى الأب هدّأ خاطر الأسرة المضطربة وطمأنهم بقوله إن الإنجليز لم يأتوا ليصوبوا مدافعهم صوب المنازل الآمنة، إنما ليطفئوا نيران الثورة الملتهبة أينما امتد لهيبها، وقد أمرهم وشدد عليهم في ألا يفتحوا نافذة من النوافذ التي تواجه الميدان، كما حذر عليهم الخروج من باب المنزل إلا للضرورة التي لا محيد عنها. وكان الصبي لا يكاد يترك النافذة طوال نهاره قاعداً يرنو بنظره من خلف «الشيش» يشاهد الإنجليز وهم يذهبون ويجيئون تارة يغنون ويلهون، وتارة يتمرنون، وثالثة يتأهبون للقتال إذا ما نمى إليهم خبر بقيام إحدى المظاهرات العظيمة.
ولم يكن الصبي يعجب لشيء عجبه لغذائهم لأنه لم يعهد غذاء على هذا النحو من قبل، وكان يتحدث عن «الطعام الملخبط» كثيراً وبلا انقطاع. ومن الغريب أنه آنس بالإنجليز وعطف عليهم لجمال وجوههم، حتى كان كثيراً ما يلعب كعادته أمام الدار دون أن يخشاهم، بل كان يقترب منهم حتى كلمه بعضهم، وصاروا يقدمون له أنواعاً من الفطائر والحلوى، ولكن أباه كان جاهلاً بهذا الأمر ولا يدري ـ حتى ـ عن خروجه شيئاً.
ولقد فات زمن طويل والإنجليز معسكرون أمام المنزل وأهل المنزل لا يدعهم القلق ساعة واحدة، إلا الصبي الذي كان مسروراً بوجودهم ـ وأخيراً انسحب الجند وذهبوا إلى معسكر آخر، وقد كان فرح الأهل عظيماً لا حدّ له، كما كان حزن الصبي عميقاً لا غور له.
***
وكان الصبي يجلس كل مساء في «حجر» أمه أمام والده، وهذا يقص ما قرأه عنه في الجرائد، ومن ذلك علم الفتى بأن سعد باشا زغلول نُفي إلى خارج القُطر، وأن الثورة في أشد حالاتها هولاً وفظاعة. وكان يسمع كذلك بحوادث القتل وإطلاق الرصاص وفرقعة القنابل في الميادين الواسعة - كما كان يسمع بالجنود التي وجدت مقتولة ومسلوبة من الأسلحة في الأزقة والحواري، حيث يتحرش بهم الوطنيون.
وفهم كذلك أن هناك وزيراً يُدعى نسيم باشا، وآخر يُدعى ثروت باشا، وأنهما مبغضان مكروهان لأسباب لا يعرف عن تفاصيلها شيئاً، وكل ما هناك فهما عدوان لسعد زغلول المحبوب، بل المعبود من الشعب كله!
ودارت الأيام وابتسم الحظ ولو ابتسامة غامضة، إذ سرعان ما أعادت السلطة الغشومة سعد إلى وطنه بعد عذاب التشريد ووحشة الغربة وآلام المرض، وأصغى الصبي إلى وصف الاحتفال الذي استقبل به الزعيم بشيء من الذهول وعدم التصديق.
وفي يوم وصول الزعيم الخالد مرت مظاهرة بالميدان الممتد أمام المنزل وجمع فيه يسوقون حماراً يضربونه بقوة ويصيحون «أحيه يا نسيم يا بو عقل طخين [تخين]»، وآخرون يضحكون ويهللون، وهكذا غرق الشعب في سروره ونسي كل شيء بعودة رئيسه سالماً كما كان، ولم يكن إنسان يستطيع النطق إلا ويهتف باسمه «يحيا سعد .. يحيا سعد» .. وفاض حبه على النفوس حتى غمرها فأحبته الناس وأحبهم.
لقد أراد الإنجليز بنفي سعد أن يقضوا على الثورة ويقضوا عليه، فازدادت الثورة اشتعالاً وعظم سعد نفوذاً وهيبة، فقد كان استعمال الشدة مع سعد وزملائه كمن يستعمل «التهوية» لإطفاء النار فيزيدها اشتعالاً واضطراماً. وكان الصبي يشترك في المظاهرات، إذ حدث ذات يوم وكان الصبي في المدرسة أن هجم بعض الطلاب عليهم وأمروا ناظر المدرسة أن يغلقها ويصرف الطلبة، وعليه فقد وجد الصبي نفسه يسير بلا وعي في وسط آلاف من الجمهور ولكنه أسرع بالذهاب إلى منزله وهو يرتجف رعباً وفرقاً.
وفي وسط هذه الآلام التي اجتاحت البلاد زمناً طويلًا لم ينسَ الصبي آلامه الخاصة التي أهمها مواظبته على الذهاب إلى المدرسة بلا انقطاع. وكان يترقب في نفسه أن تقوم مظاهرة وتطوف بمدرسته حتى تغلقها ويستريح من المدرسة ومن نظامها المرهق ومعلميها المبغضين لقلبه، كم كان يكرههم ويخشاهم، هم الذين لم يكلموه إلا بالعصا الغليظة تهوي على جسمه الصغير الضعيف، وفي ذات صباح وكانت الثورة على أشدها قصد الصبي إلى مدرسته تصاحبه خادمة ـ كثيراً ما كان ينكل بها أثناء لعبه ولهوه ـ ولما وصل إلى بابها سأل أحد فراشيها: هل الدخول مباح، أم ممنوع بسبب الهياج والمظاهرات؟ فقال له الفراش: إن من يريد الدخول من الطلبة فليدخل لا حرج عليه، ومن لا يرغب في ذلك فليذهب حيث شاء.
وهنا قال الصبي: «أنا من الذين سيذهبون حيث شاءوا»، ثم ودعه وانصرف، وأخذ يغري الخادمة بأن تكتم أمره لدى والديه وتخبرهما إذا سألاها ـ كما سيخبرهم هو ـ بأن المدرسة مغلقة أبوابها، فرجاها لذلك ودعا لها ووقف أمام مقام سيدنا الحسين مادّاً كفيه الصغيرتين، ولم ينسَ أن يهددها إن هي خالفت رجاءه، ولما وصلا المنزل وسألته أمه عن سبب رجوعه أخبرها بأن المدرسة مغلقة الأبواب، وأنه آب وهو مملوء الجوانح أسفاً لعدم تمكنه من حضور دروسه. ولكن أمه شكّت في الأمر وسألت الخادمة وأجابت عن حقيقة الحال بلا خوف ولا حذر، واضطروا إلى الرجوع فرجع إلى المدرسة دامع العينين محروق الفؤاد حقداً من خدعة الخادمة.
وقد كانت له عدة سوابق مع هذه الخادمة منها أنه كان يقلد الطبيب في مهنته ـ وقد كان معظم لعبه تقليداً لما يروقه من الناس أو الأشياء ـ وأثناء عمله للفتاة المسكينة عملية جراحية أحدث لها جرحاً بليغاً، وقد بكت الخادمة ونزلت سرّاً إلى أمه وروت لها الخبر وكشفت لها عن ساعدها، حيث ظهر لها الجرح بشعاً مؤلم المنظر. وقد ثار غضب الأم لذلك وضربته ضرباً أليماً، كما حاولت أن تجرحه جرحاً بليغاً كما جرح الفتاة بغير إثم إلا ليلهو ويلعب.
وفي الواقع كان شيطاناً مريداً وشاطراً خبيثاً لا يترك فرصة للذين حوله يستريحون فيها، ولم يكن يحل بمكان في المنزل إلا قَلَبَه رأساً على عقب، وأثار عليه الغضب والسخط، حتى نومه كان شاقّاً متعباً لأن عينيه لم تكونا لتغفلان إلا إذا أمر والدته أن تدلك له جسده دلكاً مطرداً حتى يرفق النعاس بجفنيه. وهذا ما كان يحدث له لما كان صغيراً جدّاً. بل كان يزيد على ذلك أنه كان يحمل أمه على أن ترفعه على كتفيها وتسير به في أنحاء البيت وتنزل به وتصعد حتى ينام، وكم قاست أمه من التعب والمشقة في سبيل راحته حتى اتُهمت بتدليله وتركها له الحبل، على الرغم من أنها كانت تضربه الضرب الوجيع إذا احتاج الأمر.
غداً: حلقة جديدة