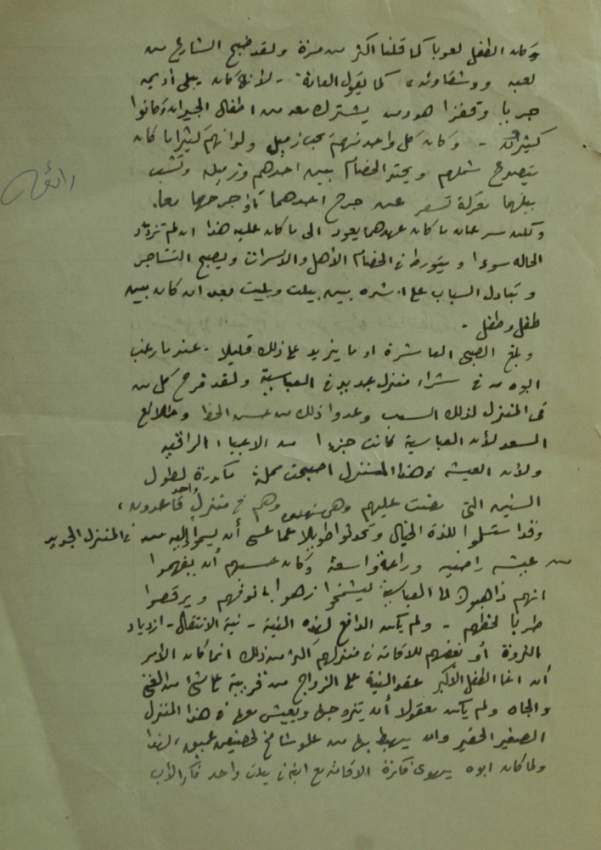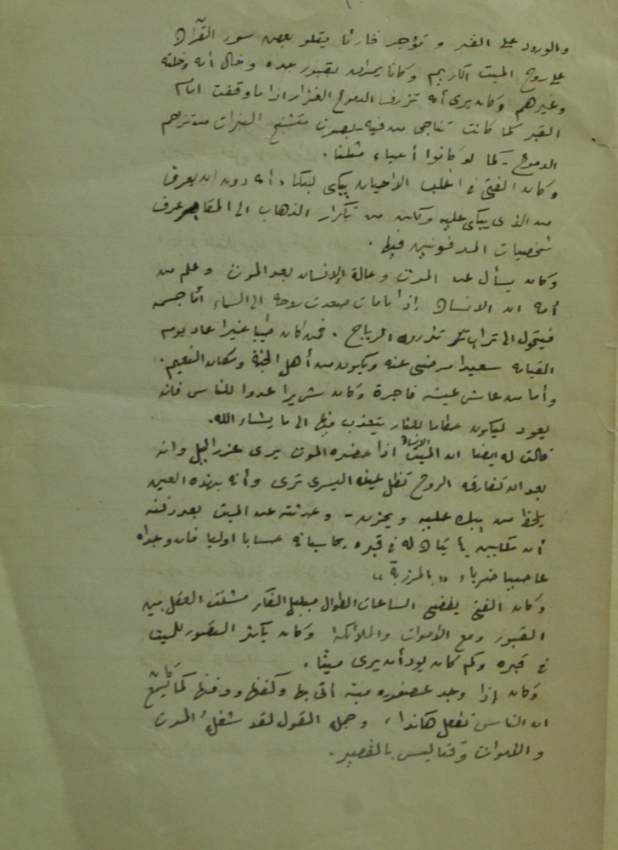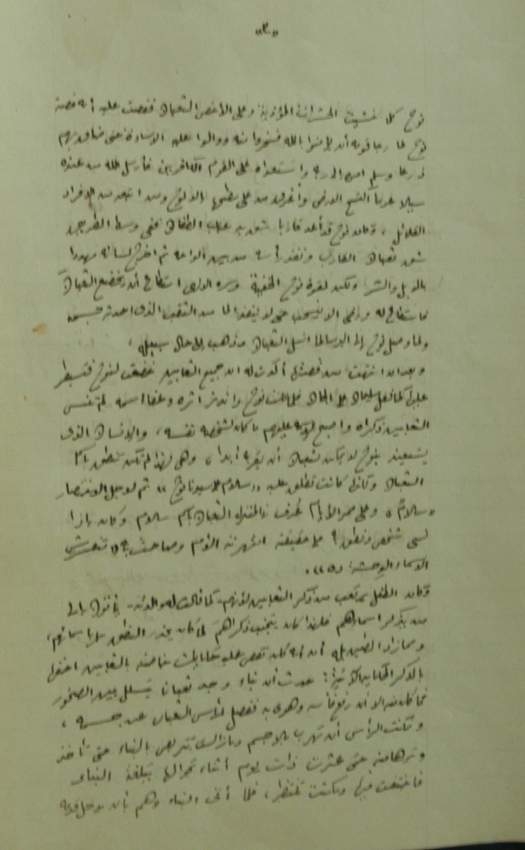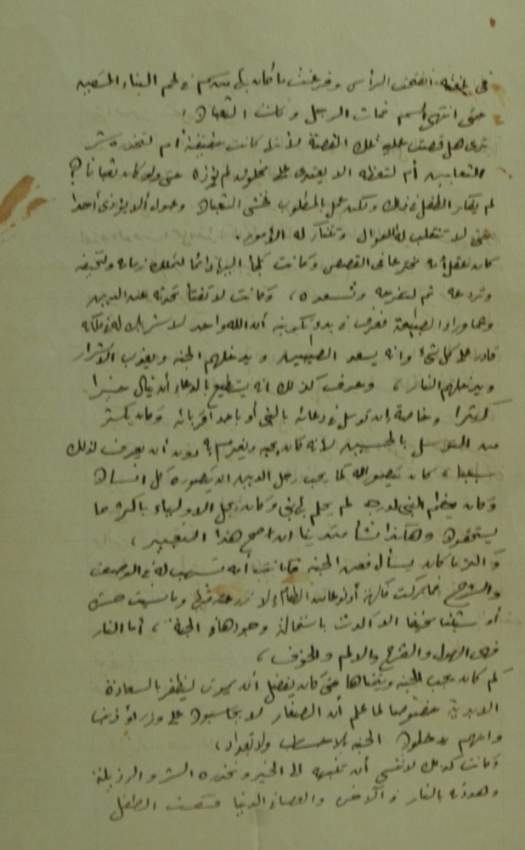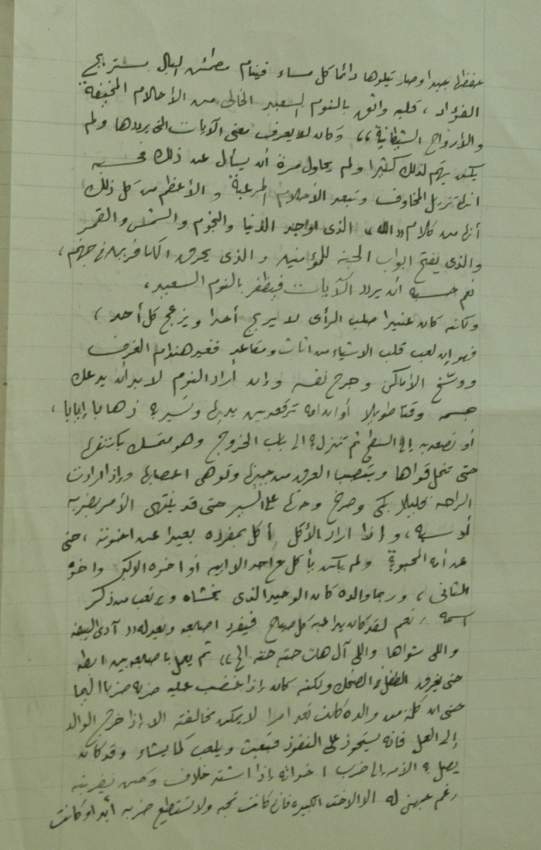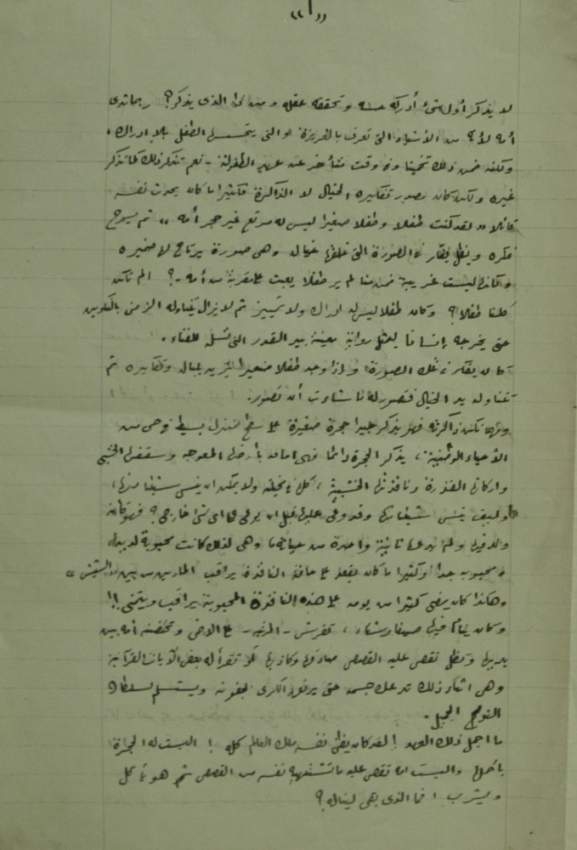2019-03-07
وفي إحدى المرات ذهبت أمه وأخته الكبرى تزوران قريبة في شارع العباسية فصحبتاه معهما تهدئة لخاطره الذي لا يستريح ما دامت أمه خارج المنزل أو بعيدة عنه. ولا يزال يذكر كيف أنه في هذه الزيارة كادت تقضي عليه سيارة طبيب وهو يسير أمام أمه وأخته، كما يذكر كيف أن أمه وأخته صرختا فزعاً من أن يصيبه سوء أو ضر، ولقد مر معهما من شارع «حسين عيد» وهو يذكر مروره منذ هذه السنوات لما مر به في هذا الشارع نفسه من الحوادث المحزنة والمفرحة والمثيرة للشجون، وبعد ذلك بسنوات طوال. وفي الواقع هو لا يذكر مروره وهو صبي يافع إلا ويشعر بحنين وألم خفي وشوق مستتر في ركن من قلبه، ولكنه شوق مجهول لشيء لا يعرف كنهه، نعم .. إنه إذا تذكر مروره منذ هذه السنوات ثارت في صدره عواطف متناقضة قد يدعوه بعضها إلى البكاء والنحيب كما يغريه بعضها بالضحك والسرور.
ولقد مر على هذا الشارع مرات أخرى غير هذه المرة لما كان يقصد هو ووالدته مصر الجديدة للدخول في «لونابارك»، وكان يعشقها لدرجة الوله، حتى إنه كان يبدأ في عد الأيام التي سيذهب إليها بعد مرورها وهو يتركها مودعاً إلى منزله. وكان لا يشترك في أي لعبة من ألعابها البهيجة لأن أمه كانت لا تشترك من جهة، ولأنها كانت تخشى عليه من الاشتراك خوفاً عليه أن يفزع، أو أن يصيبه سوء، ولكنه كان يركب معها «القارب» الذي كان يشق عباب قناة صناعية صغيرة، ومع أن القناة لم يكن يزيد غورها على متر واحد، فإن الطفل كان يفرق فرقاً عظيماً إذا ما مال القارب على أحد جانبيه ولو ميلاً قليلاً.
في الواقع، كان الصبي يخشى الماء والأنهار والبحار، حتى إنه لو حدث وكان راكباً تراماً، وكان الترام مارّاً بإحدى القناطر المركبة على النيل، فإنه يغمض عينيه حتى لا تقعا على منظر الأمواج الرهيب، وكانت تحدثه نفسه بإمكان سقوط القنطرة بالترام حيث يتحتم الموت غرقاً، وكان ريقه يجف لمجرد التفكير في هذا الخاطر المرعب.
وكانت أمه تشير عليه بأن يتمتم بالجملة الآتية دفعاً لطارئ الخوف واستجلاباً لعطف الله حتى ينقذهم من كل خطر أثناء مرورهم على الكوبري «بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله توكلت على الله وسلمت أمري لله، تكالي واعتمادي عليك يارب، اللهم نجني كما نجيت نوحاً». وبعد أن يتلو تلك الجملة يغمض عينيه وقد استراح باله قليلاً، ولا يبرح بين كل آونة وأخرى يسأل أمه: « هل جزنا الكوبري؟» وهكذا حتى تجيبه بالإيجاب فيفتح عينيه، ويخلع عنه رداء الخوف الثقيل، وكان إذا آوى إلى منزله يأخذ في محاكاة كل ما وقعت عليه عيناه، فتراه يأتي بسلم خشبي ويرفعه من إحدى نهايتيه ويركزه على سور حائط سطح المنزل ثم يأتي «بصينية طعام كبيرة» ويرفعها إلى نهايته العليا بحيث تمس بطرفها قضيبي السلم ويركب عليها ويدعها، فتندفع منزلقة إلى الأرض يمثل بذلك «المركب الطائش» .. وتارة يملأ طشت الغسيل ماء يشبهه بالنيل الذي يرتعب منه رعباً فظيعاً. وكانت أمه تصحبه معها إذا ما توجهت إلى المقابر كل عيد أو في مستهل رجب وهكذا، وكان يمسك لها «الخوص والورد ويسير بجانبها وهو يشم الخوص والورد» حتى إذا ما وصلا الحوش دخلا، ووضعت أمه الخوص والورد على القبر، وتؤجر قارئاً يتلو بعض سور القرآن على روح الميت الكريم، وكانا يمران بقبور جده وخال أمه وخالته وغيرهم، وكان يرى أمه تذرف الدموع الغزار إذا ما وقفت أمام القبر كما كانت تناجي من فيه – بصوت متشنج النبرات تزاحمه الدموع - كما لو كانوا أحياء مثلنا.
وكان الفتى في أغلب الأحيان يبكي لبكاء أمه دون أن يعرف من الذي يبكي عليه، ولكن من تكرار الذهاب إلى المقابر عرف شخصيات المدفونين فيها.
وكان يسأل عن الموت وحالة الإنسان بعد الموت، وعلم من أمه أن الإنسان إذا ما مات صعدت روحه إلى السماء، أما جسمه فيتحول إلى تراب تذروه الرياح. فمن كان طيباً خيّراً عاد يوم القيامة سعيداً مرضيّاً عنه ويكون من أهل الجنة وسكان النعيم. وأما من عاش عيشة فاجرة وكان شريراً عدوّاً للناس فإنه يعود ليكون حطاماً للنار يتعذب فيها إلى ما يشاء الله.
قالت له أيضاً إن الإنسان الميت إذا حضره الموت يرى عزرائيل، وأنه بعد أن تفارقه الروح تظل عينه اليسرى ترى، وأنه بهذه العين يلحظ من يبكي عليه ويحزن، وحدثته عن الميت بعد دفنه أن ملكين يأتيان له في قبره يحاسبانه حساباً أوليّاً، فإن وجداه عاصياً ضرباه «بالمرزبة». وكان الفتى يقضي الساعات الطوال مبلبل الفكر مشتت العقل بين القبور ومع الأموات والملائكة، وكان يكثر التصور للميت في قبره، وكم كان يود أن يرى ميتاً.
وكان إذا وجد عصفورة ميتة أتى بها وكفنها ودفنها كما كان يسمع أن الناس تفعل هكذا، وجملة القول لقد شغله الموت والأموات وقتاً ليس بالقصير.
***
وكانت أمه تصحبه معها وتسوقه في الضواحي مثل مصر الجديدة والجيزة والهرم، وكان أعظم ما يلذ نفسه ويملأها خفة وسروراً هو ركوبه الترام وإرساله النظر إلى الحقول ترعى فيها الأغنام، وكان لا يتصور حياة يمكن أن تساوي حياة الفلاح سعادة وخيراً، ولعله كان مخطئاً ولعله كان مصيباً!
ولقد هام هياماً عظيماً بالريف، ولو أنه لم يعش فيه يوماً من أيام حياته، وكان يتضرع إلى أمه أو أخته أن تقصا له حكايات يكون أبطالها الفلاحين، ويكون المسرح الذي مثلت عليه الحقول الواسعة الجميلة حيث الطبيعة سافرة ساحرة.
وكانت أخته الكبرى تسافر سنويّاً إلى عزبة قريب غني لهم، فكانت تروي القصص مكذوبها وصحيحها حتى تشبعت مخيلته بعفاريت الترع ولصوص الحقول والأحوال الريفية المختلفة .. وكان يُسر لها سروراً لا يعادله سرور، بل كان يعد نفسه أسعد الناس إذا ما استمع إلى قصة تروى عن الفلاحين. ولهذا عشق ابنة عمته وهي سيدة كبيرة تقطن الريف مع زوج مزارع، وكانت تزور منزل أب الطفل كل عام مرة، وكان يتمنى قربها ويود لو أنها تقيم معهم طوال حياتها، لتبرد علته المحترقة إلى استماع حكايات وقصص!
ولا ريب أن حكايات الجن التي كانت تُحكى أمامه قد أثرت في مخيلته تأثيراً شنيعاً، وكبلت نفسه المتوثبة بحبال الخوف والجبن اللذين لم يتخلص منهما إلا بعد زمن طويل بعد أن حلل بعقله معتقداته فوقف على موضع السخف منها وازدراها ازدراء لا ازدراء بعده، وسخر منها ومن الذين أوهموه فيما مضى بأنها حقيقة لا خيال فيها، بل وسخر من نفسه لأنه تأثر بتلك الترهات ولأنه صدق بلا وعي ما يعد تصديقه سخافة وحمقاً.
وكان الطفل لعوباً كما قلنا أكثر من مرة، و«لقد ضج الشارع من لعبه وشقاوته» كما يقول العامة، لأنه كان يبلي قدميه جرياً وقفزاً، هو ومن يشترك معه من أطفال الجيران وكانوا كثيرين، وكان كل واحد منهم يحب زميله، ولو أنهم كثيراً ما كان يتصدع شملهم ويحتد الخصام بين أحدهم وزميله، وتشب بينهم معركة تسفر عن جرح أحدهم أو جرحهما معاً. ولكن سرعان ما كان عهدهما يعود إلى ما كان عليه، وإن لم تزدد الحالة سوءاً ويتورط في الخصام الأهل والأُسر ويصبح التشاجر وتبادل السباب على أشده بين بيت وبيت، بعد أن كان بين طفل وطفل.
وبلغ الصبي العاشرة أو ما يزيد على ذلك قليلاً، عندما رغب أبوه في شراء منزل جديد في العباسية، ولقد فرح كل من كان في المنزل لذلك السبب وعدوا ذلك من حسن الحظ وطلائع السعد، لأن العباسية كانت جزءاً من الأحياء الراقية، ولأن العيشة في هذا المنزل أصبحت مملة مكدرة لطول السنين التي مضت عليهم وهم في منزل واحد قاعدون، وقد استسلموا للذة الخيال وتحدثوا طويلاً عما يمكن أن يسموا إليه في المنزل الجديد من عيشه راضية وراحة واسعة، وكان حسبهم أن يفهموا أنهم ذاهبون إلى العباسية ليشمخوا زهواً بأنوفهم ويرقصوا طرباً لحظهم - ولم يكن الدافع لهذه النية - نية الانتقال - ازدياد الثروة أو بغضهم للإقامة في منزلهم أكثر من ذلك، إنما كان الأمر أن أخا الطفل الأكبر عقد النية على الزواج من قريبة على شيء من الغنى والجاه، ولم يكن معقولاً أن يتزوجها ويعيش معها في هذا المنزل الصغير الحقير، وأن يهبط بها من علو شامخ لحضيض عميق، لهذا ولما كان أبوه يهوى فكرة الإقامة مع ابنه في بيت واحد، فكر الأب في شراء منزل ذي دور واحد، وقد أعانته على ذلك أموال كثيرة كان الابن الأكبر يوفرها عند أبيه، وكان في النية بناء دور ثانٍ بمال أبي العروسة، وقد تم كل ذلك، فاختير المنزل ولم يكن جميلاً جدّاً، ولكنه كان في نظرهم بالغاً نهاية الجمال والفخامة، إذ إن بيتهم الذي تركوه لم يكن شيئاً بجانبه.
ولقد زار الصبي المنزل الجديد متفرجاً وبلغ إعجابه به منتهاه، ولعل حديقته الصغيرة استهوته أكثر من أي شيء آخر، كما أن الحقل الممتد أمام المنزل من الجهة الخلفية استحوذ على لبه وعقله. وفي يوم الانتقال ودع الصبي أصدقاءه فرداً فرداً وهو يقول «سنرحل إلى العباسية»، ويعلو صوته عند النطق بكلمة العباسية زهواً وافتخاراً على إخوانه الذين لن يتركوا البيوت القديمة المهدمة ولن يدعوا الحي القذر. وركب مع الأثاث في عربة نقل كبيرة.
ولقد مر على هذا الشارع مرات أخرى غير هذه المرة لما كان يقصد هو ووالدته مصر الجديدة للدخول في «لونابارك»، وكان يعشقها لدرجة الوله، حتى إنه كان يبدأ في عد الأيام التي سيذهب إليها بعد مرورها وهو يتركها مودعاً إلى منزله. وكان لا يشترك في أي لعبة من ألعابها البهيجة لأن أمه كانت لا تشترك من جهة، ولأنها كانت تخشى عليه من الاشتراك خوفاً عليه أن يفزع، أو أن يصيبه سوء، ولكنه كان يركب معها «القارب» الذي كان يشق عباب قناة صناعية صغيرة، ومع أن القناة لم يكن يزيد غورها على متر واحد، فإن الطفل كان يفرق فرقاً عظيماً إذا ما مال القارب على أحد جانبيه ولو ميلاً قليلاً.
في الواقع، كان الصبي يخشى الماء والأنهار والبحار، حتى إنه لو حدث وكان راكباً تراماً، وكان الترام مارّاً بإحدى القناطر المركبة على النيل، فإنه يغمض عينيه حتى لا تقعا على منظر الأمواج الرهيب، وكانت تحدثه نفسه بإمكان سقوط القنطرة بالترام حيث يتحتم الموت غرقاً، وكان ريقه يجف لمجرد التفكير في هذا الخاطر المرعب.
وكانت أمه تشير عليه بأن يتمتم بالجملة الآتية دفعاً لطارئ الخوف واستجلاباً لعطف الله حتى ينقذهم من كل خطر أثناء مرورهم على الكوبري «بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله توكلت على الله وسلمت أمري لله، تكالي واعتمادي عليك يارب، اللهم نجني كما نجيت نوحاً». وبعد أن يتلو تلك الجملة يغمض عينيه وقد استراح باله قليلاً، ولا يبرح بين كل آونة وأخرى يسأل أمه: « هل جزنا الكوبري؟» وهكذا حتى تجيبه بالإيجاب فيفتح عينيه، ويخلع عنه رداء الخوف الثقيل، وكان إذا آوى إلى منزله يأخذ في محاكاة كل ما وقعت عليه عيناه، فتراه يأتي بسلم خشبي ويرفعه من إحدى نهايتيه ويركزه على سور حائط سطح المنزل ثم يأتي «بصينية طعام كبيرة» ويرفعها إلى نهايته العليا بحيث تمس بطرفها قضيبي السلم ويركب عليها ويدعها، فتندفع منزلقة إلى الأرض يمثل بذلك «المركب الطائش» .. وتارة يملأ طشت الغسيل ماء يشبهه بالنيل الذي يرتعب منه رعباً فظيعاً. وكانت أمه تصحبه معها إذا ما توجهت إلى المقابر كل عيد أو في مستهل رجب وهكذا، وكان يمسك لها «الخوص والورد ويسير بجانبها وهو يشم الخوص والورد» حتى إذا ما وصلا الحوش دخلا، ووضعت أمه الخوص والورد على القبر، وتؤجر قارئاً يتلو بعض سور القرآن على روح الميت الكريم، وكانا يمران بقبور جده وخال أمه وخالته وغيرهم، وكان يرى أمه تذرف الدموع الغزار إذا ما وقفت أمام القبر كما كانت تناجي من فيه – بصوت متشنج النبرات تزاحمه الدموع - كما لو كانوا أحياء مثلنا.
وكان الفتى في أغلب الأحيان يبكي لبكاء أمه دون أن يعرف من الذي يبكي عليه، ولكن من تكرار الذهاب إلى المقابر عرف شخصيات المدفونين فيها.
وكان يسأل عن الموت وحالة الإنسان بعد الموت، وعلم من أمه أن الإنسان إذا ما مات صعدت روحه إلى السماء، أما جسمه فيتحول إلى تراب تذروه الرياح. فمن كان طيباً خيّراً عاد يوم القيامة سعيداً مرضيّاً عنه ويكون من أهل الجنة وسكان النعيم. وأما من عاش عيشة فاجرة وكان شريراً عدوّاً للناس فإنه يعود ليكون حطاماً للنار يتعذب فيها إلى ما يشاء الله.
قالت له أيضاً إن الإنسان الميت إذا حضره الموت يرى عزرائيل، وأنه بعد أن تفارقه الروح تظل عينه اليسرى ترى، وأنه بهذه العين يلحظ من يبكي عليه ويحزن، وحدثته عن الميت بعد دفنه أن ملكين يأتيان له في قبره يحاسبانه حساباً أوليّاً، فإن وجداه عاصياً ضرباه «بالمرزبة». وكان الفتى يقضي الساعات الطوال مبلبل الفكر مشتت العقل بين القبور ومع الأموات والملائكة، وكان يكثر التصور للميت في قبره، وكم كان يود أن يرى ميتاً.
وكان إذا وجد عصفورة ميتة أتى بها وكفنها ودفنها كما كان يسمع أن الناس تفعل هكذا، وجملة القول لقد شغله الموت والأموات وقتاً ليس بالقصير.
***
وكانت أمه تصحبه معها وتسوقه في الضواحي مثل مصر الجديدة والجيزة والهرم، وكان أعظم ما يلذ نفسه ويملأها خفة وسروراً هو ركوبه الترام وإرساله النظر إلى الحقول ترعى فيها الأغنام، وكان لا يتصور حياة يمكن أن تساوي حياة الفلاح سعادة وخيراً، ولعله كان مخطئاً ولعله كان مصيباً!
ولقد هام هياماً عظيماً بالريف، ولو أنه لم يعش فيه يوماً من أيام حياته، وكان يتضرع إلى أمه أو أخته أن تقصا له حكايات يكون أبطالها الفلاحين، ويكون المسرح الذي مثلت عليه الحقول الواسعة الجميلة حيث الطبيعة سافرة ساحرة.
وكانت أخته الكبرى تسافر سنويّاً إلى عزبة قريب غني لهم، فكانت تروي القصص مكذوبها وصحيحها حتى تشبعت مخيلته بعفاريت الترع ولصوص الحقول والأحوال الريفية المختلفة .. وكان يُسر لها سروراً لا يعادله سرور، بل كان يعد نفسه أسعد الناس إذا ما استمع إلى قصة تروى عن الفلاحين. ولهذا عشق ابنة عمته وهي سيدة كبيرة تقطن الريف مع زوج مزارع، وكانت تزور منزل أب الطفل كل عام مرة، وكان يتمنى قربها ويود لو أنها تقيم معهم طوال حياتها، لتبرد علته المحترقة إلى استماع حكايات وقصص!
ولا ريب أن حكايات الجن التي كانت تُحكى أمامه قد أثرت في مخيلته تأثيراً شنيعاً، وكبلت نفسه المتوثبة بحبال الخوف والجبن اللذين لم يتخلص منهما إلا بعد زمن طويل بعد أن حلل بعقله معتقداته فوقف على موضع السخف منها وازدراها ازدراء لا ازدراء بعده، وسخر منها ومن الذين أوهموه فيما مضى بأنها حقيقة لا خيال فيها، بل وسخر من نفسه لأنه تأثر بتلك الترهات ولأنه صدق بلا وعي ما يعد تصديقه سخافة وحمقاً.
وكان الطفل لعوباً كما قلنا أكثر من مرة، و«لقد ضج الشارع من لعبه وشقاوته» كما يقول العامة، لأنه كان يبلي قدميه جرياً وقفزاً، هو ومن يشترك معه من أطفال الجيران وكانوا كثيرين، وكان كل واحد منهم يحب زميله، ولو أنهم كثيراً ما كان يتصدع شملهم ويحتد الخصام بين أحدهم وزميله، وتشب بينهم معركة تسفر عن جرح أحدهم أو جرحهما معاً. ولكن سرعان ما كان عهدهما يعود إلى ما كان عليه، وإن لم تزدد الحالة سوءاً ويتورط في الخصام الأهل والأُسر ويصبح التشاجر وتبادل السباب على أشده بين بيت وبيت، بعد أن كان بين طفل وطفل.
وبلغ الصبي العاشرة أو ما يزيد على ذلك قليلاً، عندما رغب أبوه في شراء منزل جديد في العباسية، ولقد فرح كل من كان في المنزل لذلك السبب وعدوا ذلك من حسن الحظ وطلائع السعد، لأن العباسية كانت جزءاً من الأحياء الراقية، ولأن العيشة في هذا المنزل أصبحت مملة مكدرة لطول السنين التي مضت عليهم وهم في منزل واحد قاعدون، وقد استسلموا للذة الخيال وتحدثوا طويلاً عما يمكن أن يسموا إليه في المنزل الجديد من عيشه راضية وراحة واسعة، وكان حسبهم أن يفهموا أنهم ذاهبون إلى العباسية ليشمخوا زهواً بأنوفهم ويرقصوا طرباً لحظهم - ولم يكن الدافع لهذه النية - نية الانتقال - ازدياد الثروة أو بغضهم للإقامة في منزلهم أكثر من ذلك، إنما كان الأمر أن أخا الطفل الأكبر عقد النية على الزواج من قريبة على شيء من الغنى والجاه، ولم يكن معقولاً أن يتزوجها ويعيش معها في هذا المنزل الصغير الحقير، وأن يهبط بها من علو شامخ لحضيض عميق، لهذا ولما كان أبوه يهوى فكرة الإقامة مع ابنه في بيت واحد، فكر الأب في شراء منزل ذي دور واحد، وقد أعانته على ذلك أموال كثيرة كان الابن الأكبر يوفرها عند أبيه، وكان في النية بناء دور ثانٍ بمال أبي العروسة، وقد تم كل ذلك، فاختير المنزل ولم يكن جميلاً جدّاً، ولكنه كان في نظرهم بالغاً نهاية الجمال والفخامة، إذ إن بيتهم الذي تركوه لم يكن شيئاً بجانبه.
ولقد زار الصبي المنزل الجديد متفرجاً وبلغ إعجابه به منتهاه، ولعل حديقته الصغيرة استهوته أكثر من أي شيء آخر، كما أن الحقل الممتد أمام المنزل من الجهة الخلفية استحوذ على لبه وعقله. وفي يوم الانتقال ودع الصبي أصدقاءه فرداً فرداً وهو يقول «سنرحل إلى العباسية»، ويعلو صوته عند النطق بكلمة العباسية زهواً وافتخاراً على إخوانه الذين لن يتركوا البيوت القديمة المهدمة ولن يدعوا الحي القذر. وركب مع الأثاث في عربة نقل كبيرة.