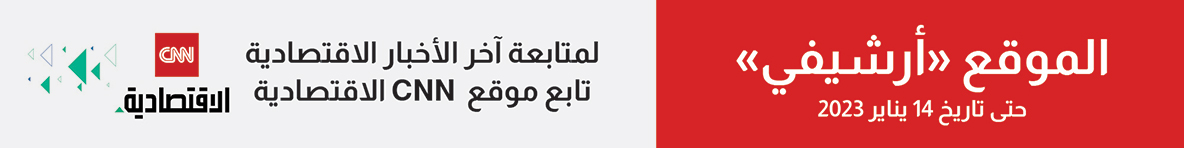2020-12-01
كثيراً ما نسمع البعض يقول: إن هذا الأمر «لا يختلف عليه اثنان»، وإن ذلك الأمر يحصل في «كل بلدان العالم»، بينما يتحدث كثيرون بأسماء الآخرين قائلين: «نحن جميعاً نعتقد بكذا وكذا»، أو «كلنا معك يا فلان»، ويخاطبون من يختلف معهم بأنه «الوحيد الذي يحمل هذا الرأي»! أو أنه «يعيش في عالمه الخاص، ولا يعلم ما يجري حوله»، وما إلى ذلك من تعابير تكشف شعوراً بامتلاك حصري للحقيقة، وتشي بتفكيرٍ إقصائي كامن في النفوس، لكنه فاعل ومؤثر.
عندما يظن المرء أنه دائماً على حق وأن الآخرين واهمون، فإنه في الواقع يؤمن بأنه وحده مطوق بالحقيقة، وغيره عاطل عنها، وعندما يؤمن بأنه «لا يوجد اثنان في الكون يختلفان» على الأمر الذي يؤمن به، وأنه يحصل «في كل دول العالم»، فإنه موغل في الثقة بآرائه دون أن يقدِّم دليلاً يدعم تلك الثقة سوى الادعاء، فهو لم يجرِ استفتاء لجميع بني البشر، كي يعرف ما يؤمنون به، ولم يَجُب العالم كي يعرف أن هذا الأمر يحصل في كل أنحائه.
احترام الآخر يبدأ بتنقية الفكر مما علق به من إلغاء للرأي الآخر، وإيغالٍ في الثقة بامتلاك الحقيقة دون الآخرين، وتنقية الفكر تُحتّم تنقية اللغة من المفردات والتعابير الإقصائية، قد لا يشعر المرء بأنه فعلاً يقصي الآخرين في ترديده هذه التعابير وأخرى مماثلة، لكنه في أعماقه يفعل ذلك دون إدراك، وإلا، لكان قد شذّب مفرداته من النزعة الإقصائية.
ثقافة الإقصاء والإلغاء لا تقتصر على بلد معين، أو ثقافة معينة، بل منتشرة في ثقافات كثيرة، وهي من بقايا عصور الاستبداد.
الرئيس دونالد ترامب، مثلاً، سُجلت عليه أقوال إقصائية كثيرة، يدعي فيها بأنه الوحيد الذي يعرف كذا وكذا: «Nobody knows better than me».
وفي المقابل، فإن هناك من يبدأ كلامه بالتصريح بأن «الجميع يعلم كذا» أو «كما تعرفون» أو «من نافلة القول» أو «لا أبيح سراً إن قلت كذا وكذا»! وهذه تعابير فائضة عن الحاجة، فإن كان «الجميع يعلم» بما تقول، أو أنه «من نافلة القول» وأنت «لا تبوح بسر»، فلماذا إذن تكرره على مسامع الناس؟ أليس الأفضل أن تضيف جديداً ومفيداً؟ ففي هذا العصر أصبح الوقت شحيحاً، والإيجاز فضيلة، وخير الكلام ما قل ودل.
عندما يظن المرء أنه دائماً على حق وأن الآخرين واهمون، فإنه في الواقع يؤمن بأنه وحده مطوق بالحقيقة، وغيره عاطل عنها، وعندما يؤمن بأنه «لا يوجد اثنان في الكون يختلفان» على الأمر الذي يؤمن به، وأنه يحصل «في كل دول العالم»، فإنه موغل في الثقة بآرائه دون أن يقدِّم دليلاً يدعم تلك الثقة سوى الادعاء، فهو لم يجرِ استفتاء لجميع بني البشر، كي يعرف ما يؤمنون به، ولم يَجُب العالم كي يعرف أن هذا الأمر يحصل في كل أنحائه.
احترام الآخر يبدأ بتنقية الفكر مما علق به من إلغاء للرأي الآخر، وإيغالٍ في الثقة بامتلاك الحقيقة دون الآخرين، وتنقية الفكر تُحتّم تنقية اللغة من المفردات والتعابير الإقصائية، قد لا يشعر المرء بأنه فعلاً يقصي الآخرين في ترديده هذه التعابير وأخرى مماثلة، لكنه في أعماقه يفعل ذلك دون إدراك، وإلا، لكان قد شذّب مفرداته من النزعة الإقصائية.
ثقافة الإقصاء والإلغاء لا تقتصر على بلد معين، أو ثقافة معينة، بل منتشرة في ثقافات كثيرة، وهي من بقايا عصور الاستبداد.
الرئيس دونالد ترامب، مثلاً، سُجلت عليه أقوال إقصائية كثيرة، يدعي فيها بأنه الوحيد الذي يعرف كذا وكذا: «Nobody knows better than me».
وفي المقابل، فإن هناك من يبدأ كلامه بالتصريح بأن «الجميع يعلم كذا» أو «كما تعرفون» أو «من نافلة القول» أو «لا أبيح سراً إن قلت كذا وكذا»! وهذه تعابير فائضة عن الحاجة، فإن كان «الجميع يعلم» بما تقول، أو أنه «من نافلة القول» وأنت «لا تبوح بسر»، فلماذا إذن تكرره على مسامع الناس؟ أليس الأفضل أن تضيف جديداً ومفيداً؟ ففي هذا العصر أصبح الوقت شحيحاً، والإيجاز فضيلة، وخير الكلام ما قل ودل.